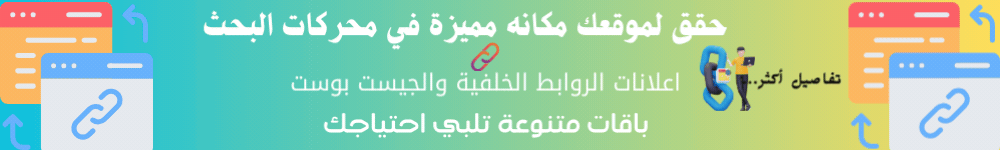دلالات الحكمة عند المفسرين والفقهاء واللغويين.. جودة التفكير وحسن التصرف

قدم عبد الصمد تَمُورُّو، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، تعريفات لكلمة الحكمة، عند المفسرين والفقهاء واللغويين المتخصصين، سعيا منه لإنارة المجال الدلالي والمفهومي لهذه الكلمة.
وأوضح الأكاديمي ذاته ضمن مقال توصلت به هسبريس معنون ب” بين الحكمة واللاحكمة” أن الحكمة تعلم الثبات والتريث والتأكد والحكم بالخبرة واليقين وليس على الشبهة والغموض، بينما الفلسفة تعلم الروية والتمييز، معتبرا هذه الأخيرة( الفلسفة) الطريق الإنساني الأفضل للاقتراب من الحكمة.
وهذا نص المقال
“جَلَّ جناب الحقِّ عن أن يكون شريعة لكل وارِدٍ أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد، ولذلك فإن ما يشتمل عليه هذا الفنّ ضحكة للمغفل، عِبْرة للمحصِّل، فمن سمعه فاشمأز عنه فليتَّهِم نفْسَه لعلها لا تناسبه، وكُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلقَ له”.
ابن سينا: ” الإشارات والتنبيهات”
بما أن الفلسفة تتساءل وتسائل، تحلل وتنتقد، تقارن وتفكك، تستقرئ وتستنتج، تحاور وتساجل، تستفز وتعارض، تنظر وتعيد النظر، تفكر وتعيد التفكير، فإنها على مداخل كل إنسانية الإنسان. وبما أننا من المشتغلين بهذا المجال، ارتأينا أن ننير بعض العقول حول المجال الدلالي والمفهومي لكلمة الحكمة، حتى تفهم بالتمام ولا تستعمل دون لجام ونظرا لغلبة الفهم بالسلب والتصورات السلبية للحكمة، ولتسهيل الأمر أكثر على من يخلطون بين الكلمات وأضدادها ولا يتبينون المعاني، فيسقطون في التعميمات التي تنبني، لا على المضامين الواهية بل على المعاني الخاطئة، والنتيجة أنهم يغلطون، وكلما كبرت مسؤولياتهم كلما كانت النتائج السلبية كبيرة؛ هكذا فغلط الطفل ليس في مرتبة غلط الأب أو المربي، وغلط الأهبل ليس هو غلط الفقيه أو رجل القانون، وغلط الساهي أو الجاهل ليس في مرتبة غلط من يتولون القيادة والرئاسة، وغيرها من الأمثلة. الحكمة تعلمنا الثبات والتريث والتأكد والحكم بالخبرة واليقين وليس على الشبهة والغموض، والفلسفة تعلمنا الروية والتمييز كما يقول الكندي ومسكويه.
1 –حـول الحـكـمـة
1.1 – معنى المعنى
يقول الشريف الجرجاني في كتابه “التعريفات”: «المعنى: ما يُقْصَدُ بشيء»، ويضيف: «المعاني: هي الصور الذهنية من حيث إنه وُضِع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تُقْصَدُ باللفظ سُمِّيَت معنى، ومن حيث إنها تَحْصُلُ من اللفظ في العقل سميت مفهوما، ومن حيث أَنه مَقولٌ في جواب ما هو سُمِّيت ماهية، ومن حيث ثُبوتِه في الخارج سُمِّيت حقيقة، ومن حيث امْتِيازه عن الأغْيار سميت هوية». [2]
إن هدفنا الدائم هو تكوين معنى للأشياء، لا يهم إن كانت ملفوظة أو مفهومة، إن كانت حقيقة أو تعبر عن تغاير مع المعاني الأخرى؛ لا يهم إن كانت موجهة إلى حديث داخلي أم لحصول الفهم عند الآخر. ليس للجرجاني وحده سلطة تعريف المعنى، حتى في ثقافتنا الخاصة، كل الثقافات والحضارات اهتمت بالمعنى: آلاف المعاجم والكتب، وآلاف التمظهرات الفكرية للإنسان هي في المعنى، المعنى ماء الثقافة والفكر واللغة والتواصل، بدونه تهلك وتنمحي. كل فرد له الحق، بل من واجبه، تحقيقا لإنسانيته، أن يبحث عن المعنى. ومن حقوق الإنسان أن يعبر عن رأيه بخصوص كل القضايا التي يرى لها معنى في حياته.
يقول ابن سينا في كتابه ” التعليقات”: “المعنى العام لا وجود له في الأْعْيان، بل وجوده في الذِّهْن.”[3]
2.1–اللغة كضرورة:
عندما نعبر عن معنى ما لتبليغه للآخر المفرد أو للآخرين كمجموعة فإننا ننتقل إلى حقل المواضعات التي نتفق عليها لضمان التواصل، وأهم منظومة رمزية تواضعت عليها المجموعات البشرية هي اللغة؛ إنها ذلك الخزان من الممكنات والتركيبات المعجمية والدلالية، التي يوظفها مستعملو اللغة بطرق مختلفة (كلام، كتابة، إشارات…)، وبأشكال متعددة (كتب، رسائل، قصص …)، ويهدفون أساسا، من استعمالها، إلى تحقيق التواصل بتبليغ الآراء والمعلومات والأفكار والتمثلات وفق سياقات متنوعة، إما عامة مثل السياقات الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية، أو خاصة ترتبط بمستعمل بعينه مثل التعبيرات الذاتية عن الرأي الخاص أو التاريخ الشخصي وغيرها.
اللغة أداة للتواصل والتبليغ، أداة يتفوق بها الجنس البشري على باقي الأجناس، إنها الخزان الذي وضع فيه كل ما أنتجه، ليس في الماضي فحسب، بل بعث به نحو المستقبل، نحو كل الأجيال الآتية. إلا أن للغة حمولات أكثر من التواصل، فقد تمثل شعبا أو قومية أو حضارة أو حقبة بكاملها. واللغة العربية من هذا النوع الأخير من اللغات، فلها أدوار التواصل والتبليغ والتخزين، إلا أن لها حمولة القداسة والحضارة والانتماء والهوية والمعتقد، ما يجعلها مثار نقاش وجدال واجتذاب وتجاذب.
3.1 – العقل كضرورة:
العقلانية ضرورية، إنها أهم خاصية وجودية متأصلة لتمييز الإنسان عن باقي الموجودات، وأهم مكوناتها؛ ونعني بها كل ما قامت به أو تقوم به الإنسانية، بشكل فردي أو جماعي لإدراك مكونات المحيط، باستعمال كل قدرات العقل؛ أي إن العقلانية هي حصيلة ومنتج عمليتي التَّعقلنِ والعقلنة المستمرتين من طرف أعضاء الجنس البشري لفهم العالم؛ لا مجال للاستغناء عنها، فبدونها تنتفي الثنائيات “المنطقية” والأخلاقية المتأصلة فينا، التي هي أساس حضارة التقنية والتقدم. بدون العقلانية لا يمكن للبشرية أن تراكم المعلومات ولا الوصول إلى قوانين تنفي الاحتمالات الخاطئة على أساس ثنائية الصواب والخطأ.
ولنكن واقعيين حسب الأطر المتحكمة في الجنس البشري: تصوروا تعدد القيم إلى ما لا نهاية. هل يمكن للقاضي أن يصدر حكما؟ والملقن المربي كيف سيحقق تقدما في عملية التعليم؟ حتى حَكَم أي رياضة، كيف له أن يتخذ قرارا إذا كانت الإمكانات لا حصر لها. بل تصوروا أن تكون لكل كلمة ما لا حصر لها من الدلالات والاستعمالات، كيف يمكنكم أن تفهموا شيئا ما؟
لا يمكن تطبيق أي قانون ولا حتى قانون السير، فنحن عندما نسوق السيارة نحتاج إلى ثنائية المباح والممنوع. في مجالات النشاطات المجتمعية كل القواعد والقيم والمعايير مبنية على هذه الثنائية. أغلب قوالبنا الفكرية أو العقلانية بنيت لمدة طويلة على ثنائية الصدق والكذب، الصواب والخطأ، الإيجاب والسلب، المعقول واللامعقول. في ميادين العلاقات الإنسانية نجد ثنائيات المقبول والممنوع، المباح والمحظور، الحلال والحرام، الحق والباطل، الخير والشر… بل إن أغلب مجالات عقلانيتنا تتولى تدبيرها ثنائيات أولية ولكنها أساسية، أهمها ثنائية الماضي والمستقبل، الزمان والمكان. لكن من الخطأ اعتبار أن الثنائية لوحدها تؤطر كل مجالات الفكر البشري، حتى تلك التي تشمل الخيال الشعري والروحانيات والحس الأدبي والفني والحدس العلمي، وآفاق المغامرة الفكرية وخاصة الفلسفية، ودواخل العواطف والمشاعر، وكل التعبيرات غير المادية وغيرها مما لا أتوهم وجوده. كل تلك المجالات مركبة، لا تكتفي لا بالثنائيات العقلانية ولا الأخلاقية، بل إنها تصبح معيقة لإنسانية الإنسان وانطلاقاته المبدعة؛ قد تصبح إيديولوجيا عامة لمن لا انفتاح لهم على ذواتهم أولا وعلى غنى التجربة الإنسانية الواسعة والمستمرة مع كل واحد من النوع البشري، وأيضا مع الجنس البشري في وعيه ووجوده الجمعي.
من أكبر الأمثلة على محدودية الفكر الثنائي، أو الذي يعتمد قيمتين، هو أنه خلق بدعة “التخصص”، أي إنك تصبح خبيرا بجزء من نواة شيء من جانب زاوية محددة في ميدان ما مخصوص ومحدد؛ وكلما تخصصت إلا وازداد أفق تخصصك ضيقا بناء على قانون الثنائية الذي يحدد لك اتجاهين، هما ما يوجد ضمن نطاق تخصصك، وما يوجد خارج ذلك الإطار الذي يضيق كلما “تخصصت أكثر”؛ طبعا هذا الوضع لا يسمح لك إلا بسلوك اتجاه واحد: تخصصك الضيق.
4.1– معنى الحكمة:
وبما أننا ننتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية فإننا سنعود إلى اللغة الأساسية في هذه الحضارة، وإلى المكونات الدلالية الأولى التي اعتمدتها لفهم والدلالة واستعمال معنى “الحكمة”، ومضاداتها الكثيرة.
وتشتق كلمة حكمة من فعل “حَكَمَ”. والحُكْمُ، كما يقول ابن فارس، “أصله المَنْعُ (…) وحَكَمْتُ السفيه وأحكمته: أخذت على يده. قال جرير:
أبني حنيفة أَحْكِموا سُفَهاءَكم إنِّي أخاف عليكم أن أغضبا
والحكمة أيضا، من ذلك؛ لأنها تمنع من الجهل…”[4]وبهذا المعنى نجده واردا أيضا في بعض المعاني المرتبطة بكلمات مثل “العقل”، الذي يعقل بمعنى يمنع من الجهل ويحتفظ بالمعرفة، وكذلك بالنسبة كلمة “عقد”. والاعتقاد الذي هو عقد وارتباط بمعتقد ومنع من عدم الاعتقاد، أخيرا بمعنى “الحفظ”، أي منع معرفة ما من الضياع والنسيان.
عند المفسرين والفقهاء واللغويين المتخصصين في ألفاظ القرآن تعني الحكمة السنة النبوية، وأيضا من حيث الدلالة اللغوية تعني الفهم والعقل. ونورد هنا تعريفين يختصران هذه الرؤية اللغوية وارتباطها بالعقيدة الإسلامية.
– يقول الراغب الأصفهاني: ” …والحِكْمَةُ: إصابة الحق بالعلم والعقل. فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء، وإيجادها على غاية الإحكام. ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات”.
– يقول الجرجاني: “…وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة: في القرآن بتعلم الحلال والحرام. وقيل الحكمة في اللغة: العلم مع العمل، وقيل الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في الأمر نفسه بحسب طاقة الإنسان. وقيل كل كلام وافق الحق فهو حكمة، وقيل الحكمة هي الكلام المعقول المصون عن الحشو”.
والدليل على هذا الارتباط العضوي بين الدلالات اللغوية والمضامين الدينية هو أن الشافعي، في كتابه الرسالة، يستعمل كلمة الحكمة بمعاني العقل والفهم والعلم والمعرفة، ثم بمعنى السنة النبوية، بل إنه يضيف ما ينتج عنهما، لذلك نجده يستعمل الحكمة بمعنى الحلم والعدل.
5.1- المعنى الفلسفي للحكمة
– الفلسفة هي الطريق الإنساني الأفضل للاقتراب من الحكمة، إنها طريقة في الوجود بواسطة الأفكار.
اهتم الفلاسفة والحكماء منذ البدايات الأولى بأغلب مجالات تفكير وفعل وقول الإنسان: اللغة، التاريخ، السياسة، الدين، الأخلاق، العلوم، الآداب، الفنون، القانون، حيثما تجد الإنسان تجد الفلسفة؛ كما اقترنت لديهم معاني كلمة الحكمة بمعاني كلمة الفلسفة.
حسب المعنى الفيلولوجي اليوناني، تعني محبة الحكمة. لكن علينا ألا نقف هنا لأن الدلالات الأصلية لهذه الكلمة لها تقاطعات ترتبط أيضا بالحكمة، وهي كالتالي:
1- “صوفيا” في اللغة اليونانية تعني “فن العيش” أو “طريقة العيش” وفق الأخلاق، أو بالطريقة المقبولة والمعقولة، وذلك بالابتعاد عن كل إفراط، ومواجهة مصاعب الحياة بتعقل ورزانة.
2- تعني أيضا المعرفة التي تعمد إلى معرفة الأسباب والعلل الأولى، وكما كان يقول أرسطو: “الحكيم هو العالم أو الذي يعرف”.
3- لا يمكن الفصل بين مكوني هذا المعنى المركب: الحكمة هي حب المعرفة واتباع السلوك المتزن والرزين، لذلك فإنها جمع بين جودة التفكير وحسن السلوك.
4- يعتبر فيتاغورس (580 – 500 ق. م ) نفسه صديقا للحكمة أو محبا لها، وذلك من باب التواضع الحقيقي، لأنه يعتبر أن وحده الإله يمتلك الحكمة.
5- وعلى هذا الأساس فالفلسفة بحث وليست تلقينا، كما يقول كانط، ليست امتلاكا للحقيقة، فالفيلسوف باحث عن الحقيقة، محب لها، وليس مالكا لها أو مالكا ليقين نهائي.
نتيجة لهذه المعاني، لا يسقط الفيلسوف في العدمية والتشاؤم وفكر الاستحالة والإقصاء، كما أنه لا يسقط في فرحة اليقين والمطلق وسعادة المعرفة المطلقة. لا يشعر بالرضا والقناعة بالمعرفة التي حصل عليها، لذلك فإنه في بحث دائم وتساؤل مستمر عن المعنى والدلالة.
هكذا تتميز الفلسفة برزانتها وتمحيصها، أكثر من الكم المعرفي الذي يتحصل منها. لذلك فالفلسفة هي طريقة في الوجود والحضور الإنساني، أكثر مما هي امتلاك وتحكم وفرض للرأي. ومن ثمة فالفلسفة نهج نقدي يحاول تمكيننا من مسافة فاصلة مع الأفكار المسبقة والجاهزة والأحكام القطعية والهستيريا الإيديولوجية الجماعية؛ إنها لا تؤمن بنهاية للفكر والنظر والتساؤل والحوار وتبادل الأفكار، بل إن المتتبع يلاحظ بأنه حتى تعريف الفلاسفة والمتفلسفين للفلسفة، بطبيعته جدلي، وفي كثير من الأحيان جدالي. المهم أن تعريف الفلسفة نفسه خاضع للتفكير والتحليل والتساؤل والنقد والمراجعة.
الفلسفة في حقيقتها، فلسفة للفلسفة، لذلك فتدريس الفلسفة ليس تدريسا لها من الخارج، إنه تعبير فلسفي وإنساني، كما أن تلقي الفلسفة لا يعني كمية من السطور والصفحات المدونة. إنها تتطلب أكثر من ذلك، تتطلب التمثل الفلسفي والحركية الفكرية والأفق النقدي والحس الفني والمعرفة التاريخية والتمكن من ناصية اللغة والمفهوم والمعاني والدلالات، والتشبع بعلو النظر الشمولي والتساؤل الدائم، وبقوة كل ما سبق يجب الالتزام المستمر بحسن السلوك الصالح والتفكير المُتَّزِن.
– الحكمة هي جودة التفكير وحسن التصرف.
لا تتحقق الحكمة إلا بحصول الإثنين، أي عند توفر التأمل والنظر وفق الحكمة، وعند اقتران الفعل والعمل والسلوك وفق الأخلاق الفاضلة.
الحكمة أساس التعليم الحق، والمعرفة الأصيلة الإيجابية وفق الحق، وهي مصدر وركيزة السلوك القويم؛ إنها تعلمنا كيف نسلك سبل التفكير الجيد والبَنّاء الذي لا يضاد الحق، تعلمنا كيف نعرف أنفسنا ودواخلها، تعلمنا حدود معارفنا وذواتنا، تعلمنا سياقات الالتقاء مع الآخرين والاعتراف بجميلهم، تعلمنا أسس الوجود والموجودات.
الحكمة هي مبتغى الفلسفة، إذ في حقيقتها هي السبيل إلى انتقال المفكرين والفلاسفة، ومن يسير على دربهم، من مراتب اليومي والعادي إلى مقام العارفين والحكماء.
ليس كل الفلاسفة بحكماء، أما المتفلسفون أو مهنيو الفلسفة فهم متدربون، قد يصيبون نصيبا من الفلسفة، لكن من المحال أن يستظلوا كلهم بظلال الحكمة، إذ من الصعب الممتنع حصول الفكر الجيد والسلوك الأمثل لكل من تحركت الأفكار في دماغه، فليست الحكمة نافورة مفتوحة وميسرة لينهل منها كل عطشان.
ترتبط الحكمة بالمعرفة في أرقى صورها وأكثرها كمالا، وبذلك تضاد المعرفة المزيفة والمغلوطة والظرفية. المعرفة المرتبطة بالحكمة معرفة بجوهر الإنسان والوجود والعلاقة بينهما، إنها معرفة بالفعل وبإمكانيات الفعل وفق الحق والأخلاق.
ليست الحكمة برنامجا للعمل بهدف الربح والريع والمنفعة، إنها برنامج يعتمد العطاء والتطوع، المؤمن بالفعل الإيجابي المفيد والنافع لأكبر قدر من الناس، لذلك ارتبطت بحسن التدبير وبالسلم والأخلاق النبيلة وحب الحياة والعدالة والخير والحق.
2 –حول اللاحكمة
قد تكون اللاحكمة هي مناقضة الحكمة والروية والتعقل، قد تكون هي الخطأ في الرأي أو التقدير أو التعبير، قد تكون هي العبث والغباء، وقد تكون أخطر من ذلك عندما تكون مقصودة لذاتها لقتل التفكير والوعي والفهم والحرية وإنسانية الإنسان، ولخدمة الظلم والاستعباد والاستبداد والقهر.
على الإنسان أن يكون في مستوى الفهم والتحليل، وأن يتحلى بقدر ولو يسير من العقل النقدي، الكفيل بالتمييز بين المنظومات النظرية العامة، التي في شكلها العام، تبدو، في إغراء حقيقي، وكأنها ترياق ملائكي وإكسير لا مثيل له في الإجابة على سؤالات الحيرة والتيه لدى إنسان الأزمات. وما يغذي نجاحها، جموح الأهواء وإرادة السلطة والتغلب، وغلبة الفردانية والانتهازية، ورفض الاختلاف، ورفض الاعتراف بالخطأ أو عدم الفهم.
ينبغي أن نتيقن تمام اليقين ألا أحد من البشر في زماننا الراهن يمتلك الحقيقة لوحده أو كاملة، وألا أحد يستطيع امتلاك كيمياء السعادة ومفاتيح الخير التام وأسرار الحياة والموت. لا أحد يستطيع أن يفرض الخير بالقوة، ولا أن يزيل الشر بالتمام دون أن يكون فهمنا للخير وتحديدنا للشر فهما جماعيا مرتبطا بحاجاتنا الجماعية ومساراتنا التاريخية.
لا يعوض النحيب والبكاء، ولا الخطاب التخديري، ولا الاختفاء وراء جرم الآخر أو الاستغراب الغبي أمام الأحداث والمسارات التاريخية المنفلتة.
لا يعوض الحديث الماضوي، الذي يتمسك بحتمية، ليست بأيدينا وبأعذار تخفي الحقائق الواضحة. لا يعوض كل ذلك عن تفحص منفتح، وتأمل ذكي ومستمر، وحوار متواضع، وانطلاق نحو المعرفة، وممارسة تؤمن بأن أفعالنا لنا، وأن نتائجها من مسؤوليتنا وأنها سوف تبقى ممارسة لا غير، لا حقيقة لها إلا في إبانها.
لا تستطيع كل المجتمعات تحمل الخسارة الفادحة، أو مقاومة الاستلاب التام للوعي التاريخي، أو تحمل مشاعة الجهل والفوضى، ولا تحمل كل أنواع العدوى من المجتمعات القريبة والبعيدة، لأن عالمنا قرية صغيرة ولأن هناك كسورا لا تُجبَر.
– السيرة وفق الحكمة:
السيرة وفق الحكمة أو ما نسميه “السيرة الحِكَمِيَّةُ”، هي السير نحو المعرفة المرتبطة بالحق، وليست تجميعا كميا للمعارف، إذ كم من مُتَعالم ليس له مثقال ذرة من الحكمة، وكم من حكيم لم يجلس يوما بمقعد بالمدرسة أو الجامعة.
السيرة الحِكَمِيَّةُ هي السير بعيدا، بحسب الاستطاعة الإنسانية، عن الأهواء والنزوات والنعرات، والكِبْر والتَّكَبُّر، والانتهازية ومزالق الأنانية الضيقة، وإغراءات التحكم والدراهم والدنانير.
السيرة الحِكَمِيَّةُ تظهر بجلاء في تواضع صاحبها واعترافه بالآخرين، فالحكيم الحق قلما ينسب إلى نفسه الحكمة، بل رأيه وسلوكه يفضحان حكمته ويفرضان علينا احترام هذه الصفة فيه.
السيرة الحِكَمِيَّةُ جهد ومجاهدة كل وقت وحين، في كل سياق وعند كل حدث، عند كل عطب أو أزمة، أمام كل تحد أو امتحان، أمام الذات والضمير، وأمام ما ينبغي أو ما لا ينبغي قوله أو فعله.
نظرا للتاريخ الطويل للحماقات الكثيرة للإنسان والإنسانية، ونظرا للأعطاب المتعددة التي يشهدها عصرنا الراهن، نحتاج، ليس فقط، إلى حكماء متفردين معزولين نقيم لهم الاحتفالات والتماثيل، ونتخذهم عبرة ومثالا، بل نحتاج إلى حكمة جماعية بل كونية. علينا أثقال تتجاوز طاقة الأفراد الألمعيين، إذ علينا الحفاظ على مقدرات وثروات كوكبنا ودعم حقوق كل إنسان والحفاظ على البيئة، وكذا حماية الأفراد والشعوب من الطغيان وخلق ثقافة للسلم ومنع الحروب ومناهضة كل أنواع التمييز، بل ومواجهة حروب الإبادة وويلات التهجير، وكلها أهداف تهم كل البشر ولذلك فهي كونية تتطلب عقلا حكيما جمعيا بل كونيا باستمرار، وأنواع من التدبير وفق ذلك.
ليس من الحكمة أن نستصغر أهمية الحكمة في ضمان مستقبل الإنسانية، لكن كما قال مسكويه مخاطبا أبا حيان التوحيدي: “ومن عَرَفَ طبع الزمان وأهله، وشيمَة الدَّهر وبَنيهِ، لم يطمَعِ في المحال، ولم يتعرَّض للممتنع، ولم ينتظر الصَّفْوَ من معْدِنِ الكَدَرِ، ولم يطلُبِ النعيم في دار المِحْنَةِ”.