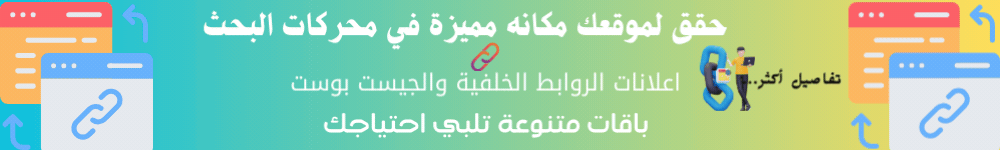مبادرة تتأمل “المنجز الفلسفي” بالمغرب

مبادرة جماعية تتأملُ منجزَ الفلسفة المغربية المعاصرة، صدر جزؤها الأول، في إطار سلسلة تروم التعريف بأعلامها الفكرية، وجيلها الجديد، وتوجه نداء “للشباب كي يطلعوا على هذا المنجز الفلسفي في تنوعه وتجدّده، اطلاعا واعيا، يقرأ بعين فاحصة ناقدة، مستحضرا سياقات القول ومراميه، آلياته ومضامينه، مرجعياته ومطالبه.”
كتاب “في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر-قراءات وأنظار”، صدر عن منشورات فريق البحث في الفكر الكلامي والفلسفي بالمغرب والأندلس بجامعة عبد المالك السعدي، بإشراف وتنسيق من الأكاديمي أحمد الفراك، يعلن مقصد “حفز الطلبة والطالبات على الاطلاع والكتابة، خطوة خطوة حتى يستأنسوا باللغة الفلسفية، وينخرطوا في فحص إشكالاتها، وتقويم استدلالاتها.”
يبحث هذا الجزء الأول من السلسلة في منجز أسماء من قبيل: محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمن، محمد وقيدي، حمو النقاري، بنسالم حميش، محمد مساعد، سالم يفوت، مع دفاعه على “أصالة البحث الفلسفي والمنطقي في المغرب.”
يقول الكتاب: “لا شك أن للمغاربة حضورهم البارز في حقل الدراسات الفلسفية العربية والإسلامية، إذ اطلعوا على التراث الفلسفي مبكرا وتفاعلوا مع ما وصلهم من نصوص فلسفية ومنطقية بالشرح والتلخيص والاختصار، وحافظوا على هذا الاهتمام إلى يومنا هذا، حيث نلاحظ تنوع اهتمامات الباحثين في الفلسفة في الجامعة المغربية بتنوع فنون القول الفلسفي ومدارسه في العالم.”
ويتطرق تقديم العمل الجماعي إلى اهتمام المغاربة بالنصوص الفلسفية ابتداء من القرن الثاني الهجري، ففي المكتبة الملكية بالرباط نجد نسخا نادرة جدا، مثل “كتاب أفلاطون، وفيه تصحيحات جابر وأقواله”، لأبي موسى جابر بن حيان الكوفي (ت200ه)، وكتاب “حكم فلاسفة اليونانيين لذي القرنين” لمؤلف غير مذكور، وكتاب “السياسة في تدبير الرياسة” لأرسطو، وكتاب “قانون السياسة في تدبير العقل والرياسة” لأرسطو (322ق.م)، ومقالة في علم الفراسة لأرسطو، وكتاب “العشرة مفاتيح” لديموقريطس الفيلسوفي (459 ق.م)، و”الشفاء في الحكمة” لابن سينا (ت428ه)، و”مقاصد الفلاسفة” للغزالي (ت505ه).
ومن المؤلفات المخطوطة أيضا، كتاب “أسهل الطرق إلى فهم المنطق” للحسن بن علي الماجري (ت668ه)، وهو أول مغربي مسلم كتب في المنطق الصوري، و”إيساغوجي” (الكليات الخمس) لأثير الدين الأبهري (ت663ه)، و”إيساغوجي” لإبراهيم البقاعي (ت885ه)، و”الكليات في المنطق” لابن البناء العددي المراكشي (ت721ه)، و”تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية” لقطب الدين محمد الرازي البويهي المعروف بالقطب التحتاني (ت766ه)، و”الخريدة في المنطق” لعبد الرحمن بن الحاج السلمي (ت1232ه)، بالإضافة إلى عشرات الشروح والتقييدات والتعليقات، على السلم المنورق وعلى غيره، وعدد كبير من النصوص ضمن تملكات العلماء والأعيان المغاربة.
وفي الزمن المعاصر، يسجل الكتاب “تفاعل الفلسفة المغربية المعاصرة مع الفلسفة العربية الإسلامية القديمة، جنبا إلى جنب مع المدارس والمذاهب الفلسفية المعاصرة، والعمل على نقل مضامينها وإشكالاتها إلى العقل المغربي المتفلسف، للنظر فيها تحليلا ونقدا وتقويما، كما تفاعلت أيضا مع قضايا ومشكلات الواقع الثقافي والسياسي المغربي والعربي، وانخرطت في الجواب عن أسئلته.”
وحول الداعي إلى الاهتمام بطيف واسع من المشاريع والكتابات الفلسفية، ذكر الكتاب أن “الاشتغال الفلسفي المغربي لم يكن على نمط واحد ولا من داخل مدرسة محددة، وإنما تعدد وتباين وتدافع، وحالفه النجاح أحيانا كما أصابه الفشل أخرى، ولعل هذه الميزة تُثري الخوض الفلسفي ولا تُضعفه، وتُغنيه ولا تُفقره، فالحوارات النقدية بين المشتغلين بالتفلسف وهي تستصحب المرجعيات الفكرية لأصحابها أفادت في إبراز قيمة الفكر الفلسفي في اختلافه ونسبيته كما كشفت حدوده واستعمالاته.”
ويقول منسق الكتاب أحمد الفراك: “انخراطا في مضمار الاعتراف بفضل متفلسفة بلدنا، وإسهاما في مراجعة الأعمال الفلسفية التي أنجزوها، اقترحنا مبادرة على طلبتنا في سلكي الدكتوراه والماستر، وخاصة طلبة وحدة “فلسفة مغربية”، لتشجيعهم على إعداد قراءات من اختيارهم لعيِّنة من المؤلفات المغربية المعاصرة في مجال الفلسفة، وخاصة تلك التي اشتُهر أصحابها بتقديم رؤى فكرية لها حضورها الوازن في الساحة الثقافية”.
ومن بين الأسماء التي حضرت وستحضر في الأجزاء المقبلة من السلسلة: محمد عزيز الحبابي، نبيل الشهابي، محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمن، جمال الدين العلوي، عبد العلي العمراني جمال، حمو النقاري، بنسالم حميش، سالم يفوت، محمد المصباحي، محمد وقيدي، عبد السلام بنعبد العالي، المهدي بنعبود، أحمد السطاتي، عبد المجيد الصغير، محمد ألوزاد، محمد مساعد، الحسان الباهي، بناصر البعزاتي، محمد المصباحي، وأسماء أخرى من الأجيال الثلاثة السابقة، ثم تجارب “جيل جديد من الباحثين الشباب الذين أنجزوا بحوثا فلسفية لا تقلُّ أهمية عن سابقاتها”، وتسجل “في جميع الأحوال، الحضور المغربي في بيت التفلسف المترعة أبوابه.”