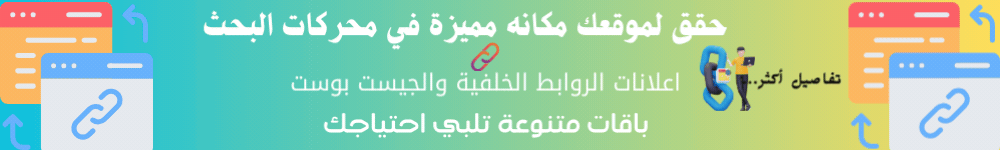“عين الكبريت”.. جوهرة درامية تعيد كتابة تاريخ المغرب في العهد المريني

بعيدا عن الرؤى الاستشراقية عن المغرب في السينما العالمية، تشاء الأقدار أن يخرج إلى الوجود عمل فني مغربي تاريخي استثنائي، مثل جوهرة نادرة من قاع المحيط الأطلسي أو كنز دفين تحت جبال الأطلس المهيبة، إنه سلسلة تحمل عنوان “عين الكبريت”، تتناول شخصية مولاي يعقوب الرمز الشهير للحامة المكتشفة في العهد المريني (سلالة حكمت بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي).
يسلط العمل الضوء على حقبة زمنية مهمة في تاريخ المغرب من خلال الوقوف عند شخصية “يعقوب الأشقر البهلولي” بمدينة فاس.
تميز هذا العمل الفني الفريد بالوقوف عند أدق التفاصيل في اختيار ملابس مغربية تقليدية حاكتها بدقة مصممة الأزياء ماريا الصديقي لتمثيل العصر المريني، بالإضافة إلى بناء ديكور كامل يرصد شكل حامة مولاي يعقوب في عهد المرينيين، وقد علق المخرج عهد بنسودة على هذا التدقيق بقوله هذا: “مسلسل بحجم تاريخ بلادنا”.
قصة مسلسل عين الكبريت:
يحكي هذا المسلسل التاريخي التراثي قصة مولاي يعقوب بن الأشقر البهلولي، رجل العلم والكرم والكفاح، من خلال التركيز على علاقة الحب الشاعرية التي ربطته بغيثة، ابنة التاجر الحاج حماد، ذات الصوت الرخيم، عندما كان طالبا شابا يدرس علم المنطق بجامعة القرويين بفاس ويطمح إلى التدريس بالمدرسة البوعنانية، لكن يد الحساد ستمتد إليه فيصاب بعدوى مرض جلدي (كان منتشرا حينها في المغرب)، فتنهار علاقة الحب تلك، (ظهر منافس من أبناء الأعيان، نجح في إصابة يعقوب بالجرب، ليقرر هذا الأخير مغادرة فاس والقرويين ومحبوبته حتى لا تنتقل إليها العدوى)، إثر ذلك يدخل مولاي يعقوب سلسلة مشاكل بحثا عن العلاج، في حين تواجه غيثة (رمز المرأة الوفية)، المجتمع (ممثلا في الأب الطامح إلى مزيد من الغنى) بحزم منقطع النظير.
إن جمالية العنوان المتمثل في “عين كبريت” تعكس باختصار قصة مولاي يعقوب (النبع الكبريتي)، الذي اكتشفه صدفة أو بمعجزة، والذي كانت وما زالت له فوائد علاجية أشفت مولاي يعقوب نفسه من الجرب المعدي الذي ألم به وجعله يغادر فاس ويتيه في الطبيعة. وضريح “لالة شافية”، الموجود بحامة مولاي يعقوب حاليا، ما هو إلا قبر غيثة، معشوقة مولاي يعقوب، التي هربت من منزل والدها بسبب إرغامه لها على ترك معشوقها والزواج بغيره. لقد تبعت غيثة، بسرية تامة، حبيبها وظلت تراقبه من بعيد إلى أن شفي من مرضه بفضل مياه النبع الكبريتي.
حقائق تاريخية:
تتفق كل الأساطير على جعل مولاي يعقوب رجلاً مقدسًا مارس على الأقل جزءًا من حياته مهنة “الكراب” (بائع المياه)، وقد كان هذا الرجل، حسب بعض الروايات، يضع أرباح تجارته في كيس “Choukara” مثقوب، وبذلك يترك للفقراء الذين يتبعونه إمكانية استعادة القطع النقدية التي سقطت وراءه.
تذهب بعض الروايات الشفهية إلى أن مولاي يعقوب توفي في رحلة إلى الديار المقدسة ودفن في مصر. وبالنسبة لآخرين، سيكون دفنه قد تم في جبل قندر، ضريحه فقط هو الموجود في مولاي يعقوب.
لكن مهما اختلفت الروايات الشفهية، فإن قرية مولاي يعقوب ما زالت قائمة، وما يزال النبع الذي يتدفق من باطن الأرض مباركا ومكتشفه مازال يعتبر وليا من الأولياء على مر الزمان. وما دامت المياه المباركة تتدفق، ستواصل المعجزة فعلها عبر الزمن، إنه ماء يشفي بإذن من الله.
تشير بعض المراجع إلى ارتباك متكرر وخلط بين شخصية “يعقوب الأشقر البهلولي” وشخصية السلطان الموحدي أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور بالله، الذي عاش في القرن الثالث عشر، (أو اختصاراً: يعقوب المنصور) والذي اضطر إلى استخدام مياه مولاي يعقوب بنفسه للعلاج من مرض ألم به، وترتبط بهذه الأساطير قصة لالة شافية ابنة مولاي يعقوب التي تركت نفسها تموت هربًا من خطر جسدي أو زواج فُرض عليها ولم تجرؤ أو لم تستطع رفضه.
بصرف النظر عن هذه المرويات الأسطورية، هناك عدد قليل جدًا من الوثائق المتعلقة بمولاي يعقوب. يبدو أن الإشارات المكتوبة الأولى المتعلقة بفضائل المنبع المائي موجودة منذ القرن التاسع الميلادي. حيث فيما بعد، سيرد ذكر النبع في العمل التاريخي “القرطاس” للمؤرخ علي بن أبي زراع المتوفى عام 1326، الذي ذكر فوائد ماء مولاي يعقوب وموت الولي الذي يحرسه. كما ورد ذكر مولاي يعقوب في “كتاب بيوتات فاس الكبرى” لمؤلفه إسماعيل بن الأحمر، الذي كان يعمل في قصر المرينيين، حيث يذكر النهر الذي ينحدر من الجبل المبارك حيث يوجد الآن ضريح يعقوب المنصور.
في القرن السادس عشر، أشارت العديد من الأعمال المخصصة لمنطقة فاس إلى الينابيع الحرارية لخلوان (سيدي حرازم) وكذلك لمنطقة مولاي يعقوب. لكن إذا كانت كل هذه الإشارات، مع عدم دقتها، تترك مجالًا لتفسيرات متنوعة، يبدو من ناحية أخرى أن المؤرخين المتخصصين قد اتفقوا على هوية صاحب المحطة وعلى تاريخ وفاته. كان هو ولي “الإسلام يعقوب المنصور بن الأشقر البهلولي”، من قبيلة البهلولي بمنطقة فاس، توفي عام 689 هجري (1291 ميلادي)، وهو رأي يتوافق هذا مع فترة المرينيين في القرن 13 الميلادي، حيث شاع أول ذكر معروف للفضائل العلاجية للمياه الكبريتية لنبع “مولاي يعقوب”، زيادة على شيوع صلاح هذا الرجل الذي يعتبر في المخيال المغربي الجمعي وليا من كبار الأولياء.
عين الكبريت تحظى بدراسات علمية معمقة
حظي هذا النبع الفريد من نوعه بدراسة علمية من أحد من رواد العلاج المائي المغربي، هو الفرنسي د. إدمون سيكريت (Edmond Secret)، حيث قام خلال مؤتمر بزيارة إلى مولاي يعقوب مع جمعية “أصدقاء فاس”، في 10 أبريل 1938، وبمحاولة لمعرفة الأصل البعيد لحامات مولاي يعقوب. لم أجد النص الكامل للمؤتمر، ولا سيما الجزء الذي يتساءل المؤلف فيه عن أصل الاسم، لكن مارسيل بويون (Bouyon Marcel)، الصحافي في “Le Progrès de Fez”، قدم تقريرًا عن المؤتمر بعنوان “مولاي يعقوب المعالج”. الدكتور “Secret” كشف أولاً عن يوم زار مولاي يعقوب الحامة من أجل العلاج، وواصل سرده منذ وصوله إلى مكان الحدث حتى شفائه، وقال Bouyon Marcel كذلك:
“حاول الطبيب secret بعد ذلك البحث في الأصل البعيد لحمامات مولاي يعقوب ووجد علاقة صوتية غريبة للغاية بين Aqua Youba (مياه جوبا الثاني)، ملك موريتانيا في القرن الأول للمسيحية، وأصوات عبارة (مولاي يعقوب)”.
فبدون شك أن الرومان استخدموا في مدنهم وفي عواصمهم في شمال إفريقيا كل الموارد المائية المعدنية والحرارية، وقد يكون مولاي يعقوب-أكوا يوبا-الموقع القريب جدًا من وليلي واحدا منها.
وبعد تحليل بعض النصوص العربية واستحضار قبيلة “آيت يوب” (Aït Youb) الأمازيغية التي استمر فيها تقديس هذا الولي عبر القرون، يمكننا تأكيد وجود صلة قوية بين تسمية أكوا يوبا وتسمية مولاي يعقوب.
روايات أخرى عن مولاي يعقوب:
يقول سفر التكوين إن يعقوب نام في المكان الذي يُدعى لوز. وفي المنام رأى سلمًا يمتد من الأرض إلى السماء. كان الرب في القمة وقال: “سأعطي لنسلك الأرض التي تنام فيها ويكون نسلك مثل تراب الأرض، ويمتد من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب”، أخذ يعقوب الحجر الذي صنع منه وسادته وأقامه نصبًا، وصب الزيت على القمة.
يُدعى المكان الآن بعد ذلك بيت إيل-غرفة النور-ويقال إن معبد العجل الذهبي كان قائماً هناك. لكن هذه الرواية الكاملة لرحلة يعقوب تشير إلى أنه ذهب إلى أبعد من اليهودية، (غير أن النبي يعقوب كان في القدس، استقرّ سيدنا يعقوب عليه السلام في “حيران” في شمال بلاد الشّام وقضى نحو 24 عاما في مصر وقد مات ودفن في فلسطين)، وهو ما يستبعد نسبة تسمية النبع الحراري إليه، لكن يمكن أن يكون اليهود الذين هاجروا إلى المغرب أحضروا معهم فكرتهم عن معجزات النبي يعقوب ونسبوها إلى النبع. كما نلاحظ في المغرب أنه في جميع الأماكن التي يوجد فيها ملاذ لمولاي يعقوب، توجد مياه كبريتية أو نفط أو فحم، فما سبب هذه المصادفة؟
لا شك في أن يعقوب هو رجل استثنائي، وأنه يعالج الأمراض نفسها في كل مكان بالعملية نفسها: الكبريت والنفط، وهي الفكرة ذاتها التي دافع عنها الطبيب “secret K” حينما رد اسم النبع إلى الرومان الذين عاشوا في المنطقة.
ولكن لماذا اختير يعقوب شفيعًا عند اليهود؟ هل يعقوب هذا ولي مسلم؟ نعم، بالطبع يعقوب نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويبدو أن المسلمين تبنوه وأعطوه الصفات نفسها؛ يعقوب النبي كانت له معجزات (التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها، اشتمام رائحة قميص يوسف عليه السلام، والشفاء بقميص يوسف عليه السلام…).
إن الفرضية التي اقترحها الدكتور secret والتي تعطي أصل آيت يعقوب، عين يعقوب، عين جوبا source de Juba، تبدو لي صعبة القبول، لأن هناك قبيلة تدعى “آيت يوب بن جوبا” وهذا الاسم لم يتغير، لكن هناك احتمال أنه يمكن لقبيلة “آيت يوب” الحفاظ على تقديسها لمولاي يعقوب (المريني)، أو حتى جوبا (الروماني) دون إرباك الشخصين، ما داما يقومان بالخواص العلاجية نفسها.
مرويات شفوية عن قصة مولاي يعقوب:
المروية 1:
حكم منذ زمن بعيد مملكتي فاس ومراكش السلطان “مولاي يعقوب بن منصور”. كان يقيم في قصره بشالة عندما أصيب بمرض خطير. كانت الحمى تحرقه ليلاً ونهاراً، وغطى الجسد المستهلك بالجروح، وسرعان ما تحولت الجروح قرحا. تم استدعاء أشهر أطباء المغرب والأندلس والمسلمين واليهود والنصارى إلى السرير الملكي. لا أحد استطاع أن يوقف مسيرة الشر الهائل. استدعى السلطان اليائس إلى قصره ساحرة أمازيغية من الأطلس نصحته بالتغطيس في ينبوع ساخن، يوجد على جانب واد، في أسفل جبل زرهون المبارك.
قام مولاي يعقوب بالرحلة، وفي موقع الحرم اليوم أقام خدمه الخيمة الملكية. من أول استحمام شعر السلطان بالراحة وفي نهاية الأسبوع حصل على الشفاء، وعاد سعيدا إلى قصره بشالة.
المروية 2:
مولاي يعقوب كان يمتلك عبدا أسود اسمه بلال، كان يعتز به مثل الابن. كان العبد بلال يطلب من سيده الزواج من ابنته شافية، وكان السلطان دائمًا يرفض ذلك الطلب، إلى أن أصيب بمرض جلدي اضطر معه إلى الانتقال إلى فاس للعلاج، وقد تم له ذلك. وفي يوم العودة، كان السلطان مسرورًا بصحته المستعادة، ولم يرغب في إزعاج بلال الذي نفد صبره ووافق متسرعا على تزويجه من ابنته شافية، وكرر بلا الطلب: “أريد أن أتزوج لالة شافية ابنة مولاي السلطان يعقوب بن منصور”.
انزعج السلطان جدًا من تكرار الطلب، وذهب ليجد أخته، وهي امرأة ذات مشورة جيدة، استشارها في المواقف الصعبة. قالت له: “لدينا ياقوتتان لهما قيمة لا تقدر بثمن ولا مثيل لهما في العالم كله. أرهما لعبدك بلال، وأخبره أنه إذا أحضر لك مثلهما فسوف يتزوج ابنتك”.
وبمجرد أن عرف بلال إجابة السلطان، ركض لاستشارة سيدي بلعباس (أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي( ولد بسبتة 524 هـ/1129م، أكبر أولياء مدينة مراكش وأحد رجالاتها السبعة)، وهو رجل ولي كان له سر عظيم. فقال له: “اذهب إلى الوادي بسلة واملأها بالحصى من (أسفل الوادي) ثم اذهب بها إلى السلطان”.
قال بلال: “لعن الله الشيطان، إنك تضحك علي”.
رد سيدي بلعباس: “افعل ما قلت لك”.
فملأ العبد السلة بالحصى، وجاء بها إلى السلطان. عندما أفرغ السلة، تحولت الحصى إلى ياقوت أكبر، بل وأجمل من تلك التي عرضها السلطان له.
السلطان مولاي يعقوب، ووفاء بوعده، ذهب إلى ابنته لالة شافية وكان حزينًا أمامها، وهي كانت جميلة كالقمر. قال لها:
“يا ابنتي، سأزوجك لبلال، عبدي”. لكن ابنة السلطان أقسمت أنها تفضل الموت على هذا الزواج من العبد، وانهارت بالبكاء، كانت عيناها الكبيرتان تذرفان الدموع. هذه الدموع هي التي ما زالت تتدفق من منبع لالة شافية حتى الآن.
مع كل ذلك الرفض، بدأت الاستعدادات لحفل الزفاف. في الليلة التي سبقت دخول العبد إلى منزل زوجته، كانت الأميرة التعيسة يائسة القلب إلى درجة أنها ماتت. حملت الملائكة لالة شافية إلى قمة الجبل حيث لا يزال قبرها مبجلا حتى الآن.
في تلك الليلة، ظهر سيدي بلعباس في المنام لبلال الذي ما زال لا يعرف شيئًا، وقف أمامه وفتح الكم الأيسر من قفطانه. ثم رأى العبد فتيات جميلات جدا ومزينات كالثريا يرقدن على ديوان.
فتح الولي الكم الأيمن من قفطانه ورأى العبد فتيات أجمل بكثير وأكثر تزينًا من الأوليات. قال له سيدي بلعباس: “انظر، الفتيات على اليسار هن من هذا العالم اللواتي يمكن أن تستمتع بهن، وسوف يسعدنك. أولئك اللواتي على اليمين هن حوريات الجنة التي يمكنك الاستمتاع بهن أيضًا وهن سيجلبن لك النعيم”.
وبسبب هذا الحلم، تخلى العبد عن ابنة السلطان واعتزل إلى الصحراء للصلاة والتأمل.
مولاي يعقوب، الذي كان حزينًا جدًا على فقدان ابنته الحبيبة، كان متفاجئًا جدًا بهذا الحلم.
وقال محدثا نفسه: “هذا العبد الذي لا يملك شيئًا، ولا حتى شخصه، يستطيع فجأة الاستمتاع بثروة أكبر من ثروتي، يتخلى عن مباهج هذا العالم ليعيش في عزلة، ويستحق نعيم الآخرة. أنا، سلطاني سريع الزوال ورجل بائس، هل سأظل أستمتع بخيرات الأرض وأنتظر عتبة الموت، دون أن أعرف المكان الذي احتفظ به الله لي؟”.
فترك السلطان يعقوب المنصور ثروته وأبناءه وقصوره ومحظياته وكل الكنوز، واستبدل اللون الأرجواني الملكي بلون بسيط، ليجد نفسه عارياً من اللقب الملكي وانطلق عبر العالم الواسع.
كان يتنقل من بلدة إلى أخرى، من قرية إلى أخرى، يبيع الماء لمن هم عطشى، ويحمل حقيبة دوم مضفرة بها ثقب في قاعها، بعد زمن مات في سوريا ودفن هناك.
أصبح السلطان الذي كان يرتدي الجلد الملون، رمزا للشفاء عبر العالم باسم كبير “مولاي يعقوب”.
وربما كانت هذه المروية الشفهية قريبة إلى الحقيقة نظرا لتزامن الشيخ أبو العباس السبتي مع زمن يعقوب المنصور، حيث في عام 539ه/1144م، السنة التي انتصر فيها الموحدون على المرابطين، بمقتل علي بن يوسف بن تاشفين، سافر أبو العباس إلى مراكش طلبا للعلم ولقاء المشايخ، وعمره ستة عشر عاما، وهناك بدأت تظهر كراماته.
ختاما، لقد نجح العمل الفني المعنون بـ”عين الكبريت” في استعادة الزمن المغربي، وفق مقاربة تاريخية تراثية، حيث تمكن المخرج عهد بنسودة من رصد الجانب المشرق لمدينة فاس في عهد المرينيين، من خلال قصة “مولاي يعقوب الأشقر البهلولي”، و”لالة شافية”، وقدم تحفة فنية ستظل علامة فارقة في المشهد الإعلامي.