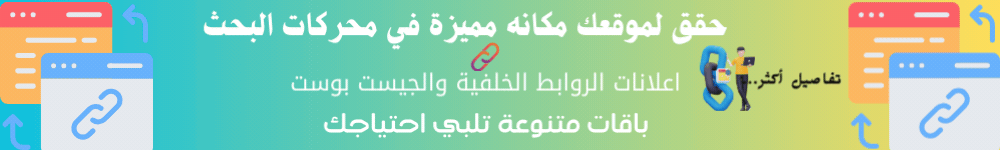الثقافة الأمل المتبقي للمغرب والجزائر .. و”الإسلام الأمازيغي” علماني

قال الروائي الجزائري أمين الزاوي إن الثقافة هي الوحيدة التي من شأنها أن توقف التجديف المتواصل بين المغرب والجزائر سياسيا، وأن تنقذ البلدين بالتالي من الانزلاق، موضحا أن الثقافة يمكنها أيضا أن تحد من الأجواء المتكهربة مؤخرا بين الشعبين المغربي والجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي وما تشهده من تحاقن وتراشق بالقذف والسب.
وشدد الزاوي، في حوار مع هسبريس، على أن الإسلام الأمازيغي ببلدان المغرب الكبير علماني بطبعه، نظرا لوجود تقاليد هوياتية عريقة تفصل بين الديني والسياسي، مضيفا أن “الإسلام السياسي ضيع علينا النهضة، وضيع علينا استلهام هذه الروح المعاصرة الموجودة في ثقافاتنا المحلية كشعوب أمازيغية”.
يمكن للثقافة أن تصلح ما أفسدته السياسة، لكن كيف تقيم المشهد الثقافي بين المغرب والجزائر، أي العلاقة بين المثقفين في البلدين بغض النظر عن القطيعة السياسية والتوجهات الرسمية وحتى بعض التوترات الشعبية؟
يبدو لي أن العالم بشكل عام، سواء في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط، مر بمراحل كثيرة من التفكك السياسي ما بين مختلف الدول العربية ودول شمال إفريقيا، أو ما يسمى بالمغرب الكبير. لقد كانت هذه التفككات والعداءات والخصامات السياسية دائما موجودة، سواء بين العراق وسوريا، أو بين الأردن ومصر، أو بين مصر والسودان، أو بين المغرب والجزائر، أو بين الجزائر وموريتانيا، أو بين المغرب وموريتانيا، إلخ…
ومما لا شك فيه أن هذه القطائع والنزاعات السياسية كانت دائما حاضرة، ولكن ما ظل قائما كوحدة، هو الثقافة. الأخيرة هي التي تجمع هذه المنطقة عندما تفككها السياسة. وكلما أصيبت الأنظمة السياسية بعطب ما، كانت الثقافة تجبر الكسور. لكن، لماذا تقوم بهذا العمل؟ أقصد مهمة أخْلَقة السياسة وجبر الكسور التي تفتعل داخلها؟ الإجابة بسيطة، وهي أن الثقافة تشتغل على الإنسان، ولا تشتغل على المشاريع الموسمية. الثقافة يهمها الاستراتيجي، والسياسة يعنيها التكتيكي.
وأعتقد أن هذا ما يجعل من الثقافة قوة ناعمة ناجعة جدا، ويمكنها أن تقاوم كل كسر في الأنظمة السياسية وتتجاوز كل ما يقع بين الدول. الثقافة محصنة، فنحن حين نقرأ قصيدة جميلة لا نبحث من أين جاءت، ولا نسأل هل جاءت من موريتانيا أو من سوريا… وحين نقرأ رواية، فالأمر نفسه، وكذلك حينما نشاهد فيلما جميلا… كل ما نقوله حينها هو أن هذا العمل يشكل إضافة إنسانية كبيرة، إنه يخدم الإنسان والقيم الكبرى. الثقافة في نهاية الأمر هي التي تقوم بعملية التهذيب والأخلقة، وكلما أخفقت السياسة، نجد الثقافة تداوي جراحها.
لكنك تعرف أن الوضع السياسي صار أكثر خطورة من أي وقت سابق بين المغرب والجزائر، وأنت رصدت ملامح التوتر في روايتك “جوع أبيض”. هل يمكن للأدب أن يصمد طويلا في مهمة أخذ المسافة أم إن التوتر صار قريبا من ابتلاع الثقافة وإقحامها غصبا في عملية التجديف الحالية؟
أعتقد أن على المثقف الأصيل والعضوي أن يحافظ دائما على المسافة، ليس بين السياسة والأدب، بما أن السياسة تحضر ضمنيا في النصوص، ولكن بين الخطاب السياسي والخطاب الثقافي، أي الخطابات السياسية الموسمية التي تسوق لفترة معينة. هذه الخطابات لا بد أن تتجاوزها الثقافة وأن يقطع معها النص الأدبي، إلا من باب النقد طبعا.
وأتصور أن قوة الإبداع والرواية والقصيدة تكمن في كونها تنظر دائما إلى الراهن لتضعه ضمن المجال المستقبلي طويل المدى. والإبداع ليس فارغا من السياسية، ولكنه فارغ من الأسلوب ومن الخطابات السياسية العابرة والمرحلية. الإبداع هو الذي يؤسس بالضرورة لخطاب مستقل بنفسه، يقرأ الخطابات السياسية بحذر، ويؤسس لخطاب نقدي فلسفي متأمل يخدم في النهاية سعادة الإنسان في كل البلدان.
لربما نحن الآن بصدد الحديث عن مشروع ثقافي بديل. ما هي المداخل التي يقترحها الزاوي كمثقف لإيقاف التجديف والتوتر ثقافيا لنفكر في مشروع ثقافي جامع لبلدان المنطقة المغاربية في ظل التشرذمات الحالية؟
هناك مساران؛ الأول هو أن يقوم كل بلد بالتفكير في ما يسمى مشروعا ثقافيا محليا وطنيا، وأن يكون في قلب الدفاع عن الدولة الوطنية. هذا المفهوم وهذا النموذج لا يجب أن نفكر فيه على ضوء السياسة فحسب، بل أيضا انطلاقا من الثقافة، أو قل التأسيس لمشروع ثقافي في الدولة الوطنية. وهذه الدول، كالجزائر والمغرب وتونس وسوريا ومصر، إلخ، ستكون مطالبة بعدم التفريط في خصوصيتها المحلية، وفقا لما تراه نافعا ومهما لمواطنيها على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، إلخ.
المسار الثاني، الذي يمثل حلما يسكن المثقفين بشكل عام، هو كيف نحول هذه المشاريع المرتبطة بالدول الوطنية إلى مشاريع جهوية متراصة ومتماسكة. وهذا يدخل في إطار العلاقات التي يجب أن تكون بين المثقفين والروابط بين النصوص الفكرية والأدبية، التي تذهب أبعد من الحدود. ويبدو لي أن هذا المسار الثاني سيكون ممكنا ومثيرا إذا سعينا للعمل على مسألتين اثنتين؛ الأولى هي التفكير في تشطيب خطابات الإسلام السياسي، باعتبارها أفسدت كل المشاريع الجهوية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
المسألة الثانية تتعلق بضرورة القطع مع النقاشات السياسية العارية، ومن ثم الدخول في نقاشات فلسفية عميقة تتيح إمكانيات تبادل النصوص العظيمة. وهذا شيء يجب على جامعات المنطقة أن تقوم به، من حيث التفكير في التأسيس لمختبرات مشتركة جهوية في الطب والأنثرولوجيا والأدب والنقد والفلسفة… وهذه المختبرات ستكون مهمتها المساهمة في وضع التصور لمشروع ثقافي جهوي.
وأود أيضا أن أثير مشكلة الإعلام، الذي أصبح يصب الزيت على النار أكثر ويجعل خدمات الثقافة محنة ومهمة صعبة. هذا الإعلام يجب محاربته، والاستئناس بالإعلام الهادئ الذي ينتقد ويقف مع بلده بلا أي عقد، لكن شرط ألا يساهم في الاحتقان وتأجيج اللهيب بين الأنظمة السياسية. حان الوقت لنقول إننا في حاجة إلى إعلام يتأمل ما هو الجرح وما هو الانكسار، وأيضا ما هو المستقبل.
تعرف أن العلمانية تعد من المفاهيم التي لم تكن محظوظة وظلت تعاني من الحيف في سياق تلقيها ضمن محيطنا التداولي، وأنت اعتبرت مرارا أن الإسلام السياسي ضيع علينا زمنا من التنمية الثقافية. في نظرك، هل كان الإسلام السياسي عائقا أمام بلوغ بلداننا مرحلة الدولة المدنية وبالتالي استيعاب معنى العلمانية؟
صحيح، وأنا أقول إن الإسلام السياسي هو الذي أفسد حتى حلمنا في النهضة. تلك النهضة التي قامت على خمسة كتب أساسية: كتاب “الاستبداد” للكواكبي، وكتاب “الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبد الرزاق، و”في الشعر الجاهلي” لطه حسين، و”حرية المرأة” لقاسم أمين، و”امرأتنا في الشريعة والمجتمع” للطاهر حداد. هذه الكتب طرقت مختلف المجالات، بما فيها علم الاجتماع والدين والأدب، وكانت هي الأرضية التي شكلت المنطلق الأساسي الذي تأسست حوله نقاشات جادة في مشروع ثقافي كبير.
لكن للأسف، مباشرة مع ظهور الإخوان المسلمين في 1928 بدأت الصحوة تغلب النهضة، وحينما انهزمت النهضة بمفهومها الجميل والفلسفي وباعتبارها الحلم الكبير والبديل الذي يؤسس لعلاقتنا مع الآخر، فشل بالضرورة ذلك المشروع الثقافي. فشل لكون الإسلام السياسي هو الذي هيمن منذ تلك الفترة على كل مفاصل الحياة، خصوصا المدرسة، وزرع في الأجيال المختلفة أفكارا مسمومة عن مختلف المفاهيم، بما فيها العلمانية.
لكن العلمانية حين نتأملها، ليست سوى مجال لتدبير الدين بشكل يحترمه، ويقوم على رؤية: “أتركوا الدين يرتاح، أتركوا الدين للناس، لطمأنينة البشر. لا تقحموه في الخصامات السياسية”. فقط، العلمانية تؤكد لنا أن الإسلام ليس بطاقة انتماء حزبية، بقدر ما هو انتماء إلى السماء، لسبب بسيط هو أننا نذهب إلى الله أفرادا ولا نذهب قطعانا. غير أن الإسلام السياسي ضيع النهضة ثم أفسد أيضا المفاهيم التي يمكن التأسيس عليها لمشروع ثقافي نظيف، كالعلمانية، باعتبارها الرؤية الموضوعية التي تفصل بين الروحي والسياسي وبين الدين والدولة.
من الواضح أن العلمانية مثل الديمقراطية، وهناك علمانيات. ويحظى النموذج اللائكي الفرنسي بانتقادات كثيرة لدى مثقفينا. من وجهة نظرك، أي نموذج للعلمانية تعتبره بالفعل ممكنا في أفقنا كأمازيغ وكعرب؟
أعتقد أن الإسلام الأمازيغي هو إسلام، إذا صح التعبير، علماني بطبيعته، فهو يفصل بين العلاقة الروحانية والعلاقات التي تسير المجتمع. لو نعود إلى تقاليدنا الأمازيغية العريقة، في هذه المنطقة في شمال إفريقيا، سنجد أن هناك عادات مهمة جدا، تبين كيف احترم الأمازيغ الإسلام حينما وصل.
لقد فهموا منذ البداية أن الدين أو الإسلام شيء والدولة والمجتمع شيء آخر. بمعنى اعتبروا أن لهم ثقافة وعادات وتقاليد لا يمكن التفريط فيها، باعتبارها مؤسسة قائمة منذ القدم وجديرة بالتقدير والاحترام، وأيضا اعتبروا أن الإسلام كدين وكإيمان جدير بالاحترام والتقدير. هذا هو الإسلام الأمازيغي.
وأعتقد أيضا أنه لو تأملنا تاريخ الطرقيات، أو ما يسمى بالإسلام الروحاني، أو الزوايا، لوجدنا أن منطق الدين الإسلامي داخل هذه المؤسسات يفصل بين أمرين، الأول حين يأتي الفرد لعيش حالة روحانية مع الله، والثاني في حياته اليومية حيث يعيش بشكل حر ومستقل. ومن ثم، إذا ما أخذنا نموذج الإسلام الأمازيغي والإسلام الصوفي في شمال إفريقيا، لأمكننا أن نزيل كل هذه التصدعات والصراعات التي أحدثها ما يسمى بالإسلام السياسي الذي ينهل من المرجعية السلفية وصحوة الإخوان المسلمين.
باقتضاب، هذا يعني أن أي نموذج للعلمانية يكون قريبا منا يجب أن يستأنس ابتداء بالثقافة المحلية، ولكن على ضوء الانفتاح على الفلسفة الغربية المعاصرة، خصوصا الأنواريين في الثقافة الأوروبية، كالألمانيين، والأمريكيين أيضا. التقريب بين الجانبين سيأتي في ظل محاولة المزاوجة بين الثقافة المحلية في بعدها الإنساني، أي الفصل الفطري بين المؤسسات، وبين الثقافة الإنسانية الكونية والفلسفة الأنوارية القادمة من أوروبا.